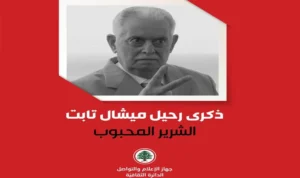إن التحول الاقتصادي العام في لبنان، وانهيار العملة، والبطالة الواسعة، وإغلاق قنوات التمويل، أنتج سوقاً سوداء اتسعت لتشمل ترويج المخدرات وغسل الأموال. والمخيم، بفضائه المغلق والكثافة السكانية والعلاقات الشبكية، أصبح بيئة مثالية لتوسع هذه الشبكات.
في حادثة مأسوية قتل الشاب إيليو أبو حنا، البالغ من العمر 25 سنة، بعد تعرض سيارته لإطلاق نار كثيف، عند مروره قرب مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وكان التقرير الطبي قد أكد أن إصابة الشاب إيليو ناتجة من اختراق رصاصة جسده من الجهة اليمنى إلى اليسرى، بينما عثر على آثار رصاص على مؤخرة السيارة وسقفها، مما يشير إلى إطلاق نار كثيف ومباشر باتجاه المركبة. ولاحقاً ونتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ستة من عناصره، كانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور. كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطناً وأربعة سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عثر على جثتها بتاريخ الـ28 من الشهر الجاري، وبوشر التحقيق معهم، وتجرى المتابعة لتسلم بقية المتورطين، وفقاً لما جاء في بيان الجيش.
وقال والد الشاب في حديث إعلامي “ابني قتل برصاص كثيف، من غير المقبول أن يسمح لأية جهة بحمل السلاح خارج سلطة الدولة، فالدولة هي الجهة الوحيدة المخولة ضبط الأمن وفرض القانون.” وأشار إلى أن الرواية الأقرب للمنطق تفيد بأن ابنه ضل الطريق نحو مخيم شاتيلا أثناء عودته من تناول وجبة طعام في منطقة بدارو (بيروت)، إذ أدى خطأ في نظام تحديد المواقع GPS إلى انحراف مساره عن طريق منزله في منطقة النقاش (جبل لبنان) نحو منطقة الطيونة (بيروت)، مما جعله يدخل بالخطأ شارعاً ضمن محيط المخيم.
في السياق، علق مسؤول العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي على الحادثة في حديث إعلامي أيضاً قائلاً “ما جرى هو أن القوة الأمنية المشتركة في مخيم شاتيلا أقامت حواجز داخل المخيم، بعد إجراءات الجيش الهادفة إلى تنظيف بؤر التفلت، وأثناء مرور الفقيد إيليو أبو حنا فوجئ بالحاجز ولم يمتثل للتوقف وسار مسرعاً، فقام أحد العناصر بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الفقيد واصطدمت سيارته بمدخل أحد المنازل”. أضاف الأسدي “على الفور، اتخذ اللواء العبد إبراهيم خليل قراراً بتشكيل لجنة تحقيق من كبار الضباط، وهي على تنسيق كامل مع مخابرات الجيش اللبناني للوصول إلى حقيقة ما جرى وتحميل المسؤوليات وإجراء اللازم بما فيه تسليم أي عنصر يطلبه الجيش (اللبناني) لتحقيقاته”.
ما قصة مخيم شاتيلا؟
يقع مخيم صبرا وشاتيلا، جنوب العاصمة بيروت، وتأسس عام 1949 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف إيواء الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا إليه من شمال فلسطين من بعد تاريخ النكبة. أما أرض المخيم، فقسم منها مؤجر لصالح “الأونروا”، والقسم الآخر ملك لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، ويضم أكثر من 8500 لاجئ مسجلين، وهو من المخيمات الفائقة الاكتظاظ، وتعرض لمجزرة صبرا وشاتيلا في سبتمبر (أيلول) 1982، مما رسخ حضوره في الذاكرة الجماعية كأحد أكثر فضاءات اللجوء الفلسطيني هشاشة وعنفاً. وتبدلت تركيبته السكانية جذرياً خلال العقد الماضي، ولم يعد الفلسطينيون غالبية صريحة، ويظهر مسح لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني عام 2017 عدد سكان المخيم بنحو 14 ألفاً، أكثر من نصفهم سوريون، ونحو الثلث فقط فلسطينيون، مع نسب أصغر للبنانيين وجنسيات أخرى. هذا التنوع ضمن مساحة شديدة الضيق فاقم الضغط على البنية التحتية والحوكمة، فالفراغ أو تقييد السيادة الأمنية داخل المخيمات، وانهيار الاقتصاد اللبناني، وأزمة تمويل “الأونروا” خلقت “بيئة ممكنة” لازدهار شبكات المخدرات والسلاح وملاذات المطلوبين.
صبرا وشاتيلا تجسيد حي لرواية “البؤساء”
في مقالة لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية نشر أواخر عام 2018، يقول “افتتحت الأمم المتحدة عام 1949 مخيم شاتيلا في لبنان للاجئين الفلسطينيين، وقد نما عدد سكانه على رغم الصراعات المتتالية. وإذا كانت ذكرى مجزرة عام 1982 التي شهدها بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً، فإنما لتدع المجال لعذابات الحياة اليومية هناك”. وغير بعيد منه، قرب منعطف على طريق سريع جنوب بيروت يجثم مخيم شاتيلا، وهو كيلومتر مربع من الفقر لا يرى من الخارج، ويستقبل الداخل بروائحه قبل رؤية المعروضات. وتصف كاتبة ة هالة قضماني المخيمين الفلسطينيين بما يعنيانه من بؤس وما يعانيانه من ظلم وحياة تعيسة وماض مؤلم، “ففي شاتيلا، تستقبل الداخل رائحة الدم المنبعثة من رؤوس الحملان المذبوحة حديثاً مختلطة بما ينبعث من السمك من روائح غير ممتعة، أمام بائع بنغالي، لا يعرف مصدر ولا اسم بضاعته بكلمات الإنجليزية أو العربية القليلة التي يخلط بينها، لكن زبائنه يشترون منه”، وتتابع قضماني “هذه الزاوية من السوق للعمال البنغاليين أو السريلانكيين، الذين يدخلون لبنان بعقد لمدة ست سنوات، وعلى بعد أمتار قليلة من هذا المخيم، يمتلك السوريون والمصريون ونادراً بعض اللبنانيين أكشاك الفواكه والخضار الرائعة”، ووفقاً لتقرير الصحيفة الفرنسية “تجذب هذه السوق الرخيصة إلى حد الثلث أو الربع بالمقارنة مع الأحياء الأخرى جميع المحرومين من مدينة بيروت، وهي ليست جديدة، فقد كانت تعرف باسم: سوق صبرا للخضراوات، قبل أن تصبح الآن سوق شاتيلا، فالمخيمان الفلسطينيان لا تفصلهما حدود واضحة، وقد أصبحا مشهورين بعد مجزرة سبتمبر 1982”.
المخيم كـ”حاضرة فقر”
من فضاء خيام إلى “حاضرة فقر” مكتظة تبنى عمودياً في أزقة ضيقة جداً، مما يعرقل الخدمات الأساسية ويخلق ظروفاً صحية وأمنية هشة. وتصف تقارير صحافية وبحثية المخيم كـ”مدينة داخل مدينة” مع طفرات سكانية بعد الحرب السورية. وبحسب “موسوعة المخيمات الفلسطينية”، “لم تتغير مساحة مخيم شاتيلا حتى عام 1969، ثم توسع وامتدت رقعته لتشمل الحي الغربي، وبعض المناطق الملاصقة للمخيم، والمخيم ليس تجمعاً عشوائياً، بل أقرب إلى القرى في تركيبتها الاجتماعية، ومعظم سكانه من منطقة جغرافية واحدة من شمال فلسطين، ومن منطقة الجليل الأعلى تحديداً. ويعتبر مخيم شاتيلا وحدة اجتماعية مغلقة، يعرف فيه الناس كل شيء تقريباً عن بعضهم بعضاً، ابتداء من المسائل الشخصية، مروراً بالأحوال المعيشية، وانتهاء بالانتماءات السياسية. وبحكم النمو الطبيعي للسكان، تضاعفت أعداد اللاجئين مرات عدة منذ عام 1948، وتلعب ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية دوراً حاسماً في تزايد عدد السكان الذين بلغوا مع نهاية 2010 نحو 425640 نسمة، مقارنة بـ422188 نسمة في التاريخ نفسه من عام 2009، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ0.8 في المئة فقط. وتعتبر المخيمات الفلسطينية بيئة سكنية مكتظة لا تتناسب مساحتها مع عدد السكان إطلاقاً، ويفترض الحصول على ترخيص من استخبارات الجيش لترميم أو بناء أي منزل جديد في المخيم”، وعيله ووفقاً لـ”موسوعة المخيمات الفلسطينية” فإن واقع السكن في المخيمات يشير، بصورة واضحة، إلى أن الفلسطينيين في لبنان، وخصوصاً سكان المخيمات، لا يتمتعون بالحق في مسكن لائق، ولم توجد لهم الفرصة أصلاً لذلك، “كل ذلك يدفع السكان إلى البناء العمودي والعشوائي، وإلى تآكل مساحات اللعب للأطفال، والحرمان من الهواء والشمس في معظم البيوت”.
وبحسب “الأونروا”، يعاني المخيم ما تعانيه كل مخيمات لبنان من فقر وبطالة، إضافة إلى تدني الخدمات. واستقبل أهل المخيم مجموعة كبيرة من الفلسطينيين، والسوريين القادمين من سوريا، بعد الحرب التي بدأت عام 2011، ووصول موجات كبيرة من النازحين السوريين وعاملات وعمال مهاجرين، فأعيد تركيب النسيج الاجتماعي داخل مساحات خانقة أصلاً.
كيف تحول المخيم إلى بؤرة مخدرات وسلاح؟
دائماً ما تنقل وسائل الإعلام عن تبادل إطلاق نار وسماع أصوات انفجار قذائف صاروخية داخل مخيم شاتيلا، بسبب اشتباكات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون، وحصلت مداهمات متكررة للجيش واعتقالات بالعشرات خلال عامي 2024 و2025، مما يشي بطابع منظم للشبكات وتداخلها مع محيط بيروت الجنوبي. ويخضع أمن الخيم لحوكمة هجينة تتألف من لجان شعبية، وفصائل فلسطينية، وشبكات أهلية وخيرية تدير الشأن اليومي بدرجات متفاوتة من الفعالية، مع تنسيق موضعي مع بلدية الغبيري (جبل لبنان) ومؤسسات لبنانية، فيما أجهزة الدولة تتحرك أساساً حول المخيم أو عبر عمليات نوعية. هذا النمط الهجين موثق في الأدبيات عن المخيمات اللبنانية، ومع غياب ولاية أمنية ثابتة وشفافة داخل الأزقة، وبنية عمرانية معقدة، تمنح المجموعات غير النظامية قدرة على الاختراق والحركة والاختباء والردع الاجتماعي.
وقد تقلص تمويل “الأونروا” منذ عامي 2023 و2024 مما أثر في العيادات والتعليم وإدارة النفايات، وكل تعثر إضافي يترجم اضطراباً اجتماعياً ويفتح شهية الفاعلين المسلحين على لعب أدوار “بديلة” في مقابل الولاء والحماية، فضلاً عن الفقر والبطالة والقيود القانونية على العمل والتملك للفلسطينيين، ومع انهيار الاقتصاد اللبناني ارتفعت معدلات الفقر، فأصبح الاقتصاد غير النظامي، أي التهريب والترويج، أكثر جاذبية وخطورة، وفقاً لتقارير صحافية وتحليلات بحثية حديثة عن شاتيلا. من هنا، فإن الفراغ الأمني النسبي داخل المخيمات وصعوبة فرض قانون روتيني على تجارة السلاح والممنوعات، وارتفاع المعروض من اليد العاملة اليائسة وشبكات الحماية، الأهلية والفصائلية، استثمرت في الاقتصاد غير النظامي. أضف إلى ذلك البيئة العمرانية الفوضوية وشديدة الكثافة، من ممرات ضيقة، وبناء عشوائي عمودي، كلها تعتبر ملاجئ آمنة ومخابئ وأوكاراً لوجستية، واستحالة مداهمات سلسة من دون خسائر جانبية. كما أن قرب المخيم من عقدة بيروت الجنوبية والأسواق غير النظامية المحيطة، يجعل التوزيع أسهل، كما الشراء والبيع والتوسط. والتداخل السكاني، فلسطينيون وسوريون ولبنانيون وجنسيات أخرى، ضمن اقتصاد نقدي هش، يسهل على الشبكات تجنيد وسطاء ونقاط بيع ونقل. ودائماً ما تصدر عن الجيش اللبناني بيانات تعلن توقيفات في حق متهمين بتجارة المخدرات، ومداهمات كبيرة داخل شاتيلا بتهمة “تجار مخدرات مهمين”، كما حصل في شهر سبتمبر الماضي، إذ نفذت وحدات من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات في المخيم عملية دهم نوعية لمستودع رئيس تستخدمه إحدى العصابات لتخزين المواد المخدرة، ومنشأة مخصصة لترويج هذه المواد على نطاق واسع في مناطق مختلفة، واشتبكت مع مطلوبين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، وأوقفت 55 شخصاً، بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.
من مشروع تحرر إلى سوق بائسة
لم يخسر شاتيلا نخبته بين ليلة وضحاها، إنما عبر تآكل بطيء ومتصاعد لـسجلين متداخلين، الأول: فقدان أفق سياسي – قانوني واضح للفلسطينيين في لبنان، أي حالة “لا جنسية” وقيود عمل وتملك، التي حولت حضور النخب من دور قيادي اجتماعي وسياسي إلى دور مساعد في إدارة نقص، والثاني: انهيار موارد الدعم والهيكلة المؤسساتية، من خدمات “الأونروا”، وشبكات التوظيف، وتمويل الفصائل التقليدية، الذي جعل من الوظائف السياسية والمناصب “مواقع بقاء”، أكثر منها مواقع مشروع وطني، والنتيجة، أن النخب لم تمح، لكنها تآكلت وظيفياً وفقدت أدواتها للنفخ في أفق جماعي ومسار مهني لجيل الشباب.
الوظيفة المزدوجة للمناصب الحركية من قيادة إلى وساطة في سوق اللا أمن
وعندما تحرم مجموعة من ضوابط الدولة والمقومات الاقتصادية، تتحول المؤسسات الفصائلية واللجان إلى “وسطاء” بين حاجات الناس والموارد الضئيلة. هذا الوساطة تنتج سلوكاً شبه بيروقراطي، أي كوادر تقرر توزيع موارد محدودة، وتدير خدمات مشروطة، وتغدو في حالات الضعف عرضة لإغراءات مادية، خصوصاً حين يصبح المال من تجارة المخدرات أكبر وأسهل من التمويل الدولي المتقلص. لذلك، القرار ليس بالضرورة “خيانة” مبدئية فقط، بل قرار براغماتي ناجم عن ضيق الخيارات وهشاشة الموارد.
السياسة تتحول إلى اقتصاد الظل
كما أن التحول الاقتصادي العام في لبنان، وانهيار العملة، والبطالة الواسعة، وإغلاق قنوات التمويل، أنتج سوقاً سوداء اتسعت لتشمل ترويج المخدرات وغسل الأموال. والمخيم، بفضائه المغلق والكثافة السكانية والعلاقات الشبكية، أصبح بيئة مثالية لتوسع هذه الشبكات. والفصائل التي كانت يوماً تملك “أدوات حماية” استخدمت جزءاً من هذه الآليات التجارية، إما كحاجز يسمح بعمل التجار، أو كغطاء، أو كقناة تفاوض لجني موارد بديلة، هذا كله يفسر الشروط التي تجعل بعض الكوادر “تتنازل” من أجل المال.
فقدان الموجه الأيديولوجي والانتقال الجيلي
وكانت النخبة السياسية الفلسطينية داخل المخيمات، ولزمن طويل، متماسكة حول سرد التحرر والحقوق. ومع تلاشي آفاق العودة، ومع تحول الاهتمام الوطني إلى صراعات ومحاور إقليمية، فقدت هذه السردية جزءاً كبيراً من قيمتها العملية. وكثيرون من الشباب، راهناً، لا يربطون حياتهم بمشروع سياسي بعيد الأمد، بل يبحثون عن دخل، وهوية، واحترام يومي. إذاً، عندما تنعدم بدائل اقتصادية واجتماعية محترمة، تتحول القيم الوطنية إلى “خطاب رمزي” بينما تستبدل ممارسات البقاء اليومية بالمصالح الآنية. هذا الانتقال الجيلي يضعف عقيدة النخب التقليدية، ويقوي منطق السوق على حساب منطق “المقاومة” والقيادة.
تداخل القوى والضغوط الإقليمية
هنا، لا يمكن إغفال دور الجهات الإقليمية والمحلية، كسوريا (نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد سابقاً)، وإيران، وقوى لبنانية وتجار محليين، التي تموه المشهد السياسي بتمويلات وتسويات موقتة. هذه الضغوط تضيق هامش المناورة للأسماء التي كانت تنظم الشأن السياسي داخل المخيم، وتحولها إلى لاعبين صغار في لعبة أكبر، حيث الولاء قد يعاد تعريفه في مقابل حماية أو نفوذ أو مال، مما يعمق هشاشة النظام السياسي الداخلي ويسرع عملية تهافت القيم.
سحق روح المخيم
والنتيجة على أرض الواقع ليست فقط زيادة المخدرات أو السلاح، بل انهيار ثقة السكان في قياداتهم، وتلاشي المساحات المدنية المستقلة، من جمعيات شبابية، ومدارس تشكلت كفضاء حر، واستبدال الأفق المشترك بأفق تعاملات يومية لحماية الرزق. هذا ما يسمى “سحق روح المخيم”، إذ تقاسم اللحمة الاجتماعية بين من يحمي سلوكه ولقمة عيشه بأي ثمن، ومن يحاول “المقاومة” بقيم ولا يملك أدواتها.
ماذا يعني هذا سياسياً؟
هذا يؤدي إلى تفكك مشروع القيادات المحلية كمصدر للشرعية، فعندما تتحول مراكز القرار إلى مراكز توزيع مادي مشروط، تسقط الشرعية. أيضاً، تعميم منطق الزبونية والعمولة، فتتحول السياسة إلى شبكة تبادل مصالح، لا إلى إدارة للمصلحة العامة. وهذا ما استقدم مزيداً من العنف، سواء عبر السوق السوداء التي تنتج نزاعات على الحصص والأرباح، وهذا بدوره يؤدي إلى تزايد أعداد المسلحين داخل الفضاء المدني.
أما لماذا قبلت بعض الكوادر المال؟
ذلك لأن البيئة جعلت من قبول المال فعل بقاء وظيفي – مادي أكثر منه “خيانة مبدئية”، كما أن وظائفهم خسرت محتواها السياسي، ومواردهم تقلصت، والبدائل الشفافة للعمل غير موجودة. هذا لا يبرر السلوك، لكنه يوضح سياقه، فالقرار متخذ داخل بنية منهكة، ليست نتيجة لكونهم “أشراراً” أصلاً، بل لأن منظومة القيم والمكافآت تغيرت جذرياً.
مخيم شاتيلا… كيف سيطرت العصابات على فضاء اللاجئين؟ .