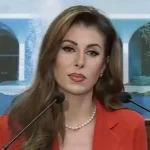يمتلك لبنان ثروة غازية بحرية تقدر بعشرات تريليونات الأقدام المكعبة، ويمكن أن تشكل فرصة اقتصادية لإنقاذ الدولة من أزمتها المالية، شرط توافر مؤسسات شفافة وقرار سيادي واضح.
ليست كل دولة تمتلك نفطاً أو غازاً تتحول تلقائياً إلى دولة مزدهرة، فالتجارب العالمية تثبت أن الثروة الطبيعية وحدها لا تكفي، وأن النجاح يرتبط قبل أي شيء ببناء مؤسسات قوية وسياسات رشيدة وبيئة حوكمة شفافة، قادرة على تحويل المورد الخام إلى قيمة مضافة.
ففي دول مثل فنزويلا وإيران، انهار الاقتصاد على رغم الثروات الهائلة بسبب تفشي الفساد وسوء الإدارة والعقوبات والصراعات الداخلية. وعلى النقيض، تقدم دول الخليج نموذجاً مميزاً لنجاح الإدارة الحكيمة للثروة، إذ اعتمدت على استراتيجيات تنموية طويلة المدى، وانفتحت على الأسواق العالمية، واستثمرت في التعليم والبنى التحتية والتكنولوجيا، فحولت النفط من مورد طبيعي جامد إلى دينامية اقتصادية دائمة الاستمرار.
هذا التباين يضع لبنان أمام مرآة قاسية، فلبنان يقف فوق كنز غازي محتمل في البحر المتوسط، تقدر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حجمه بنحو 25 إلى 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاسترداد. ولو تحققت إمكانات هذه الأرقام، قد يشهد الاقتصاد اللبناني فرصاً لتسديد جزء من دينه العام وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وخلق فرص عمل واستقطاب استثمارات ضخمة. لكن كل ذلك مشروط بعامل غائب، الدولة. فالثروة وحدها بلا مؤسسات أشبه بجريان المياه فوق أرض متشققة لا تمتصها ولا تعطي منها شيئاً.
وبالعودة لملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل، فقد شكل الاتفاق الذي وقع عام 2022 بوساطة أميركية خطوة غير مسبوقة أنهت عقوداً من النزاع، وفتح الباب نظرياً أمام استكشاف البلوك رقم 9، المتصل بحقل قانا، حيث باشرت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية أعمال الحفر الاستكشافي. ومع ذلك، ظلت النتائج الأولية ضبابية ولم تسفر عن اكتشاف تجاري مؤكد، مما أعاد النقاش الداخلي لنقطة متوترة بين الآمال الشعبية والتقييمات العلمية الباردة. كما أن الاتفاق نفسه صمم بطريقة تجعل أي استخراج فعلي مشروطاً بتسويات مالية بين الشركة العاملة وإسرائيل، مما يعني أن القرار ليس لبنانياً صرفاً، بل محكوماً بمعادلات سياسية وأمنية تتجاوز الحدود الجغرافية.
أما في ملف الحدود البحرية مع قبرص، فقد وقع اتفاق أولي عام 2007، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، وظل مجمداً بفعل عوامل خارجية، أبرزها اشتباك المصالح مع تركيا في شرق المتوسط، وتعقيدات الترسيم بين قبرص الشمالية والجنوبية، فضلاً عن تراجع المبادرة الدبلوماسية اللبنانية. وهذا التجميد يهدد موقع لبنان في شبكة أنابيب الغاز التي تتهيأ لخدمة أوروبا الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، مما يعني أن التأخير هنا ليس تقنياً وحسب، بل فرصة سياسية مهدورة.
وعلى الجبهة الشمالية، تبدو مسألة الترسيم مع سوريا أكثر تعقيداً، فمنذ عام 2014 اعترضت دمشق على الخرائط اللبنانية، ولاحقاً منحت امتيازاً لشركة روسية في المنطقة المتنازع عليها، مما زاد الطين بلة. والخطورة في هذا الملف أنه لا يمكن فصله عن علاقات لبنان العربي، مما يجعل التفاوض مشروطاً بتفاهمات إقليمية أكبر. ويبقى هذا الملف معلقاً على خريطة نفوذ سياسي أكبر من قدرة الدولة اللبنانية الحالية.
في هذا الوقت، تواجه عمليات الاستكشاف البحري تحديات غير تقنية، فالشركات العالمية العاملة في قطاعي النفط والغاز تتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً لعقود قبل الاستثمار لأنها تضخ مليارات الدولارات من رأس المال في عمليات استكشاف طويلة الأمد. وبما أن لبنان يعيش انهياراً مالياً غير مسبوق منذ عام 2019، وانقسامات حادة على مستوى القرار السياسي، فإن البيئة الاستثمارية تعدّ غير جاذبة. ولقد جرى حفر بئرين فقط في المياه اللبنانية حتى الآن، ولم ينتج عنهما اكتشاف تجاري مثبت. ومن دون تكرار الحفر وتوسيع المسوحات، لا يمكن الوقوف على صورة جيولوجية دقيقة.
في المقابل، يمكن فهم نجاح دول أخرى في المنطقة مثل مصر التي اكتشفت حقل “ظهر” العملاق وطورت صناعتها الغازية لتصبح حالياً لاعباً محورياً في تصدير الغاز إلى أوروبا. كذلك إسرائيل التي طورت حقول “تامار” و”ليفياثان” و”كاريش” وباتت تبيع الغاز للأردن ومصر. وحتى قبرص، على رغم صغر مساحتها، بنت تحالفات أوروبية للدفاع عن مصالحها البحرية. وما يجمع هذه الدول ليس حجم الاحتياط فقط، بل وجود مؤسسات قادرة على التفاوض وإدارة الصراع وتوقيع الاتفاقات بسرعة وفاعلية.
لبنان على النقيض، يعاني تجزئة في السيادة، فجزء من قراره الاستراتيجي لا يزال خاضعاً لنفوذ “حزب الله” الذي يستجلب الصراعات الإقليمية، مما يخلق انطباعاً دولياً بأن أية عائدات مستقبلية قد تستخدم خارج إطار الدولة، أو توظف في تمويل سلاح موازٍ للجيش الرسمي. وهذا الظل الأمني– السياسي يدفع الشركات إلى تجميد قراراتها، ويدفع الدول إلى رفض إعطاء “الضوء الأخضر” للتطوير.
وفي ظل هذا الواقع، طرحت الحكومة اللبنانية أخيراً بلوك رقم 8 للاستدراج، وعلى رغم أهمية هذه الخطوة تقنياً، فإنها فقدت قيمتها الفعلية لغياب الضمانات السياسية، فالشركات لا تتنافس على امتيازات تحت ظل توتر أمني وانهيار قضائي ومخاطرة بعقود قد تلغى أو تعدل سياسياً عند أول أزمة داخلية.
ومن المثير للتساؤل أن لبنان اتجه حصرياً نحو شركات أوروبية في إدارة الملف، متجاهلاً شركات عربية كبرى مثل “أرامكو” السعودية و”أدنوك” الإماراتية، إذ إن هاتين الشركتين تمتلكان تاريخاً طويلاً من النجاح في إدارة حقول معقدة حول العالم، وكان يمكنهما تقديم شراكة مضمونة سياسياً وتمويلاً مستقراً وجاهزية تقنية عالية. لكن القرار يبدو محكوماً باعتبارات داخلية تتعلق بميزان النفوذ الإقليمي والخشية من دخول رأس مال عربي قد يفرض معايير شفافية صارمة لا تتوافق مع مصالح المنظومة.
إن السؤال الحقيقي لم يعد، متى نبدأ استخراج الغاز؟ بل هل لبنان يملك دولة قادرة على إدارة ثروته البحرية؟… والإجابة حتى اللحظة لا تزال موضع شك. فحتى لو أثبتت الدراسات وجود احتياطات تجارية، فإن عائدات الغاز بحاجة إلى صندوق سيادي شفاف وقضاء رقابي صارم ومؤسسات رقابية تحارب الفساد وإرادة سياسية تغلق منافذ الهدر. ومن دون هذه الأدوات، سيتحول الغاز إلى فصل جديد من صراعات الطوائف والأحزاب، بدلاً من أن يكون رافعة اقتصادية.
في النهاية، لا يمكن للبنان أن يدخل سوق الغاز العالمية وهو غارق حتى اليوم في نزاعات سياسية داخلية، ويعجز عن انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتعيين رئيس للمصرف المركزي وإصلاح الكهرباء، كما لا يمكنه جذب الاستثمارات وهو مصنف دولياً تحت خانة “الدائرة الحمراء” سياسياً ومالياً.
إن الثروة الطبيعية ليست ضماناً للازدهار، بل اختباراً للمؤسسات والدولة. والدول التي امتلكت الغاز قبل أن تمتلك الدولة، خسرت الاثنين معاً. والدول التي بنت الدولة قبل أن تكتشف الغاز، ضاعفتهما معاً. ولبنان اليوم يقف عند مفترق طرق، لا يخرجه منه سوى قرار سياسي شجاع يعيد السيادة للدولة ويفرض الإصلاح ويستعيد الثقة. عندها فقط سينتقل الغاز من كونه “حلماً معلقاً” إلى واقع اقتصادي ملموس.
وإلى أن يحدث ذلك، ستبقى ثروة لبنان البحرية معلقة فوق أمواج المتوسط، وستبقى الخريطة غنية… بينما خزانة الدولة فقيرة.
لبنان فوق كنز بحري تحاصره دائرة حمراء ومنظومة فاسدة .